“اتركي الماعز وارعي الكلمات”
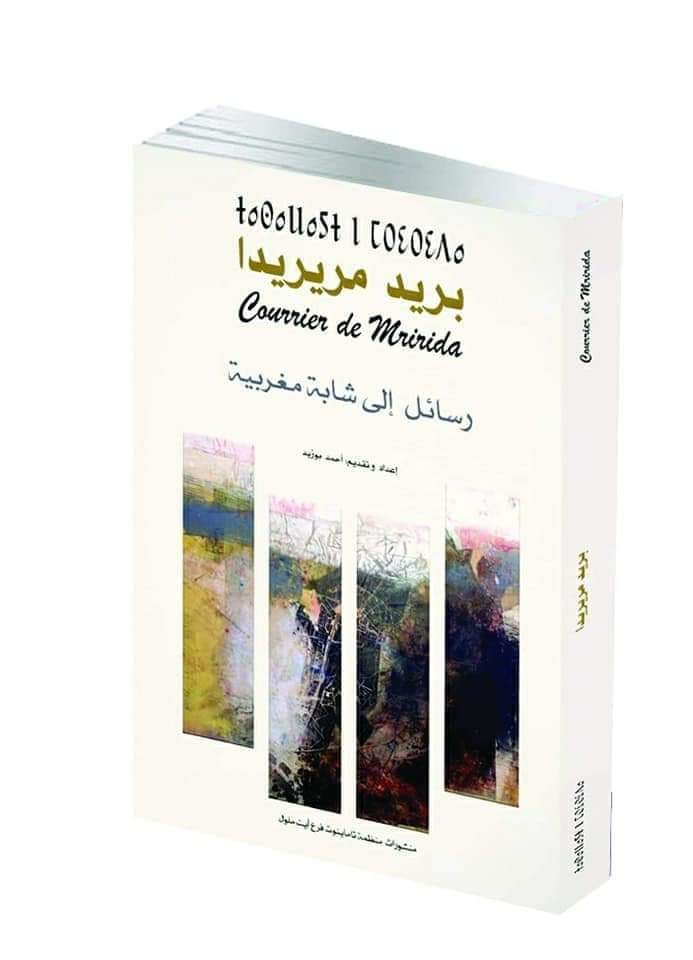
عبد الرحيم الخصار
لا أعرف اسمكِ، ولا أتذكر ملامحك على النحو الذي يمكنني به استعادة وجهك والتعرف عليك إذا ما التقينا يوما ما. غير أن ابتسامتك المتدفقة حياةً والجاهلة ظلامَ الكون لا يمكن نسيانها إلى أبد الآبدين.
وباسم هذه الأبدية أكتب إليك. ذلك أنني أومن ألا نهاية لشيء ابتدأ. الأشكال تتغير وتتحول، غير أن روح كل شكل تظل خالدة.
أحدس أن ابتسامتك قد اخترقت الكون، وزرعت في ظلام بعيد بصيصَ ضوء. فلمثل ابتسامتك ينفطر القلب الأعلى وتسري رحمته وحنانه في أرواح الخلائق.
كنتِ في عامك التاسع أو العاشر على الأرجح ترعين قطيعا من الماعز في الجبل، حين قادتني إليك يد الأيام. رأيتك وحيدة في أرض بعيدة، أنت والحجر وما تبقى من العشب. واحترتُ كيف تبقى بمفردها طفلةٌ عزلاء في مكان قصيّ ؟
– أنتِ وحدك هنا؟
– نعم
– أين والدك؟
– في أغادير. يأتي مرة كل شهر أو شهرين.
– ووالدتك؟
– في البيت
– لا تدرسين؟
– لا
– المدرسة بعيدة؟
– لا. بل قريبة
– ولماذا لا تذهبين إليها؟
– من يذهب إليها هو أخي “مولاي المهدي”.
– اسمه “مولاي”؟
– نعم
– وأنت ما اسمك؟
– عائشة.
– من سمّاك؟
– والدي؟
– ومن سمّى شقيقك؟
– والدي أيضا.
– لماذا سماه “مولاي المهدي” ولم يسمّك أنت “للّا عائشة”؟
اِكتفيتِ حينها بضحكة جميلة ولم تجدي لسؤالي جوابا. فهو سؤال فوق طاقتنا معا. ذلك أن للمجتمع خياراتِه النابعةَ من تراكم نتاج ثقافة متجذرة، ثقافة يصعب استئصالها أو على الأقل تغييرها، هكذا بشكل عفوي دون تدخلات قوية وحقيقية من الأطراف المتنورة في المجتمع. إنها ثقافة قامت ردحا من الزمن على إعطاء الأولوية في التعليم والعمل والقيادة للذكور، وبالتالي حجب البنات عن الحياة العامة وإبقائهن تحت إشارة الرجل، أو بعبارة أخرى في خدمته. وإذا كانت الأمور أقل حدّة في المدن فإن الظاهرة مازالت حاضرة في البوادي والقرى. ولرؤية الصورة واضحة أكثر ينبغي إيقاف تشغيل التلفزيون والخروج قليلا إلى الأرياف وصعود الجبال لمعرفة ما تعيشه نسبة هائلة من الإناث في البلاد بناتٍ صغيرات أو نساء راشدات سواء متزوجات أو أرامل أو سوى ذلك.
إن ابتسامتك البريئة يا صغيرتي تخفي وراءها غابة مظلمة. أنا أيضا تدحرجت من بادية وأعرف كيف يفكر الآباء المساكين في أولادهم وبناتهم وفق تقسيم فيزيولوجي مسبق. لكن ما لا أفهمه حقيقة هو كيف يمنع هذا الأب ابنته من الذهاب إلى المدرسة، بينما يسمح لنفسه أن يتركها هنا وحيدة في هذا الخلاء عرضة لكل خطر؟
دعيني أحكي لك يا صغيرتي عن صديقة لي أخرجها والدها من المدرسة. إسمها فدوى تنحدر من الجنوب، من مدينة يقال إنها محافظة. غير أننا أحيانا لا نفهم عما تحافظ مدننا الصغيرة. هل على عاداتها الجميلة وطقوسها الصافية في الحياة أم على تقاليد قادمة من ظلامٍ ما؟ والرّاجحُ أنها تحافظ على الصنفين معا.
كانت فدوى تحب المدرسة على نحو هائل، وترى فيها جنتها الصغيرة. غير أن والدها أخرجها من هذه الجنة قسرا لسبب يصعب تصديقه. أخرجها، بعد أريع سنوات من التعلّم، فقط لأنها أنثى، لأن اسمها فدوى، لا المهدي مثلا، أقصد مولاي المهدي.
بكت تلك الطفلة الجميلة وانتحبت طويلا، كما لو كانت غصنا قطعوه من شجرة. لقد كانت الكلمات والحروف وملصقات القسم وسبورته الخشبية عالما سحريا بالنسبة إليها، عالما أُبعدت عنه بجريرة لم تقترفها.
أقبلت الطفلة على قراءة الكتب بنهم وبشغف، وكان هذا النوع من القراءة انتقاما من انتزاعها من مقاعد الدراسة. صارت تقرأ كل ما كان يقع في يدها من كتب، وستعثر في يوم ما على نص شعري مختلف عما كان في كتب البيت: “مئة رسالة حب” لشاعر راحل اسمه نزار قباني. أحدث لديها هذا النص ما يشبه الاستفزاز والخلخلة، تأثرتْ به وبدأت الكتابة عل منواله. لقد كان ذلك النص هو الحبل الذي جرّها إلى أرض الشعر. صارت تقرأ كتبا أكثر، وتكتب شعرا غزيرا. كانت كتابة الشعر بالنسبة إليها تصفية حساب مع تلك السلطة الذكورية التي حالت بينها وبين حلمها. كانت أيضا انعتاقا من زجاجة ما، زجاجة التقاليد التي تمنع طفلة صغيرة من البقاء لوقت أطول على مقعد وأمام سبورة.
مرّت السنوات عجلى، وصارت فدوى واحدة من أجمل شاعرات هذه البلاد. قليلون يعرفون أن هذه الشاعرة التي تكتب قصائد رائعة بعربية جميلة وتبدع صورا مذهلة لم تدرس في الجامعة، ولا في الثانوي، ولا حتى في الإعدادي. بل إنها لم تكمل تعليمها الإبتدائي أصلا.
أنا أيضا أحلم أن أراك يوما ما، بعد أن تركت قطيع الماعز وعدت إلى مدرستك، سيدةً في هذا المجتمع لا راعية. لا بأس أن ترعي الماعز من وقت لآخر. لكن من المهم والضروري لك أن ترعي أيضا قطيعا آخر من الكلمات. العلم ليس نورا فحسب. العلم هو خلاص هذه البشرية، حديقتها الأبدية والجهل هو المقبرة.







