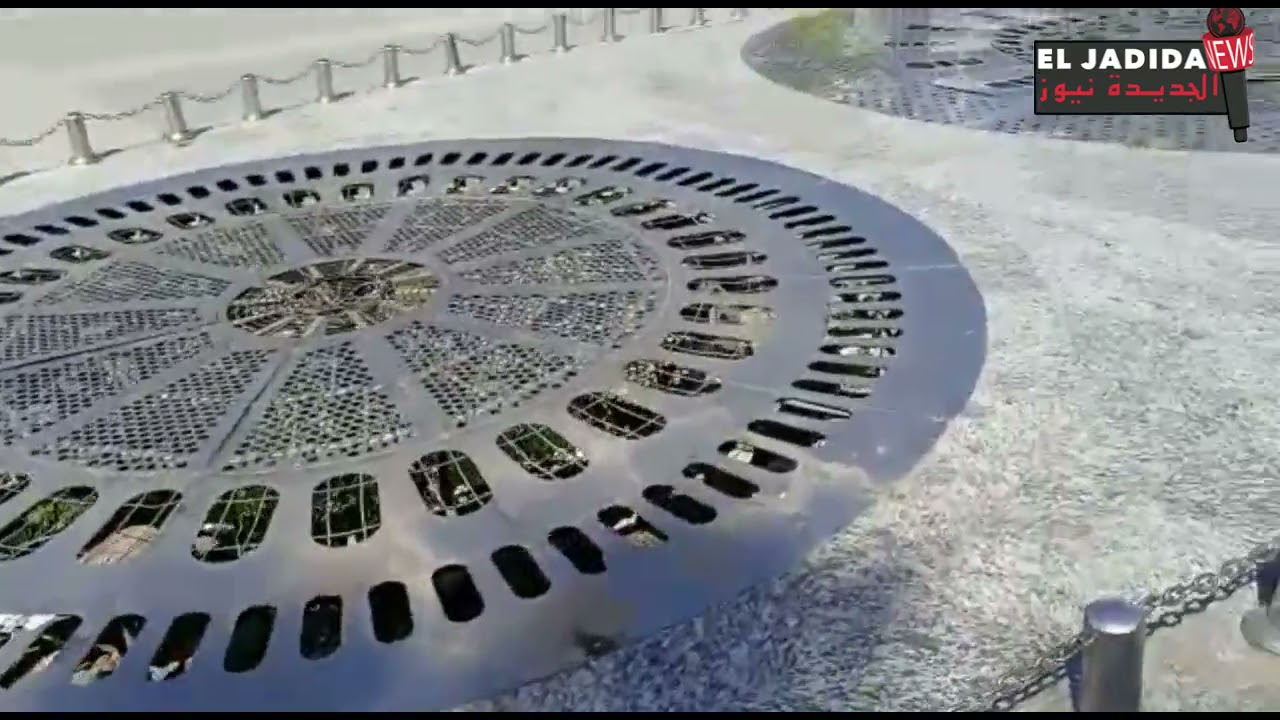لماذا تمثّل “الشعبويّة الفكريّة” لميشيل أونفراي إشكاليّة حقيقيّة ؟

ترجمة : الحسين أخدوش.
عندما صادفت نصّاً للفيلسوف «كورنيليوس كاستورياديس» ذات يوم، قرأته فأدركت، على ضوء المُؤلّف، أن انزعاجي كان كبيراً، بل وكان مصدر قلق سياسي عميق. وبصفتي فيلسوفاً وأستاذاً للفلسفة في التعليم العالي، فإنّ «عمل» «ميشيل أونفراي» لم يثر اهتمامي أبداً، وذلك لثلاثة أسباب فلسفيّة، هي:
أولاً : لطالما أراد «أونفراي» (الذي أستخدم اسمه لتيسير الحديث عن العمل) اختزال الفلسفة إلى مجرَّد مدرسةٍ للحكمة. لكن إنْ كانت الحكمة هي تشكيل حياة تدّعي أنها نموذجيّة، فإن الفلسفة حينها ستكون شيئاً آخر غير ما هي عليه الآن. إنّه في مواجهة اللّغز الراديكاليّ للعالَم، يسعى الفيلسوف إلى الإجابة عنه من خلال الإعداد اللامُتناهي للعمل المفاهيميّ. لكن بالنسبة لفيلسوفنا المزعوم، فإنّ الحياة لا تكون مستنيرة بمساعدة المفاهيم: أي إنّها في حدِّ ذاتها ستكون مفيدة لأولئك الذين يريدون رؤيتها. أمّا المظهر الفلسفيّ المزعوم الذي يعتقد أنه يمكن أن يتبنّى عبره حقيقة يمكن أن يعتمد عليها، فإنه مشكوك فيه.
ثانياً : يدّعي «أونفراي» دائماً أنّه يفضح «التاريخ المُضاد» للفلسفة؛ لكنّه مع ذلك يفترض هذا «التاريخ المُضاد» مسبقاً، بحكم تعريفه، التاريخ الذي يدّعي رفضه: أي ما يُسمَّى بالتاريخ «الرسمي» للفلسفة الذي يدرسه الأكاديميّون. بعبارةٍ أخرى، منذ البداية، يروي «أونفراي» (بنفسه) القصص، ملفِّقاً من الصفر خطاباً مهيمناً، والذي يمكن أن يؤكِّد موقف «المُتمردين».
هكذا، أمكن لـ«أونفراي» تصفية حساباته مع الظواهر الثقافيّة المعروضة له في بضع دقائق فقط، وذلك بتناولها على أنها ذات «أبعادٍ مفهومية» فقط (أو هكذا يعتقد). إنّها نوعٌ من المعرفة الشعبويّة لديه، رغم كلّ ما يزعمه من كونها حكمةً شعبيّة.
ثالثاً : باعتبار ذلك طريقته المُفضّلة، يتخيَّل «أونفراي» بأنّ الفكر يعكس بالضرورة حياة مؤلّفه. إلّا أنّه، وحسب هذا الأمر، أصبح على «أونفراي» التفكير، على سبيل المثال، في أنّه كان من الممكن كتابة عملٍ فكريٍّ رائع حتى في ظلّ وضعية وجوديّة مزرية. لذلك، ولضمان المُلاءمة، دون خلط بين عمل وحياة المُؤلّف الذي يسعى «أونفراي» إلى تشكيل سيرته، راكم هذا الأخير الأخطاء الكثيرة على عدّة أصعدة: اختصارات، اقتباسات خارج السياق، تفسيرات خاطئة، إهمال المصادر، ملاحظات لا أساس لها، إلخ.
وكلّ ذلك تمَّ لديه باعتماد أسلوب قائم على مبدأ ثنائي يتعلَّق : إمّا بالثناء، أو باللوم المُفرط .
لقد أدركت في عام 2008 عندما نشر «أونفراي» «حلم أيخمان» تماماً هذا الاحتيال. ونظراً لكون المُدَان في القدس أثناء المُحاكمة قد أعلن، في دفاعه، أنّه قام فقط «بواجبه بالمعنى الكانطي»، فإنّ الفيلسوف المُتمرِّد لم يحتج إلى المزيد للهجوم على الفيلسوف «إمانويل كانط» وإظهار أن فكره هو الذي أدّى في الواقع إلى ظهور النازية. وأيضاً في سنة 2017، في كتابه «الانحطاط – Décadence»، ذهب «أونفراي» إلى حدِّ تحميل مسؤولية الإبادة الجماعية للقديس بولس.
تعهّد «كلود أباديا» بأدبٍ شديد بإثبات، بطريقةٍ دقيقة، حدود هذا التحامُل المجنون على «كانط». لكن، المُشكلة في هذه الحالة لا تكمن فقط في أنّ «أونفراي» ينشر كثيراً، بل في كون كثير ممّا يكتبه مجرَّد هراء، وهي مع ذلك تترجَم إلى عشرات اللّغات حول العالَم، وتباع منها مئات الآلاف من النسخ. لذلك، هناك أكثر من سببٍ للذعر بهذا الخصوص.
إن التظاهر النرجسي للفيلسوف الزائف، الذي تأسره دائماً تخيُّلاته الفكريّة الخاصّة، يشكِّل عرضاً لشر يتجاوز شخصه، ويؤثِّر، كما سنرى، على الوجود المُشترك.
من «برنارد هنري ليفي» إلى «أونفراي» :
إذا كان «أونفراي» يهنئ نفسه، بطريقةٍ ما، على كونه منبوذاً من العالم الأكاديمي والمؤسّسي، في عام 2019، جنباً إلى جنب مع «بلانشو»، و«هايدجر»، و«ليفيناس»، و«فرويد»، و«فوكو»، و«ريكور»، وما إلى ذلك، فإنّه، وهو فيلسوف زائف حقيقة، قد تقوَّى بدخول كتب المئة التي تمَّ نشرها بالفعل في المجموعة المرموقة للغاية من «دفاتر ليرن» (Cahiers de L’Herne).
إن التكريم الممنوح للمُؤلّف يعني بالنسبة لنا شيئاً يتجاوز الذعر في اتجاه الخراب: هكذا قد ولّى الفكر الذي كانت ترمز إليه كراسات ليرن، وهجر بالفعل. لكن، ثم يساعدنا الفيلسوف «كورنيليوس كاستورياديس» (1922 – 1997) في فهم ما يبدو في حدِّ ذاته غير مفهوم.
في عام 1979، في مجلّة «الملاحظ الجديد – Nouvel Observateur»، رد «كاستورياديس» على «برنارد هنري ليفي» الذي هاجم للتو «بيير فيدال ناكيه». لقد انتقد المُؤرِّخ بشدّة بالفعل عهد الله، وأبلغ عن التقريبات والأخطاء والاختصارات الأخرى لمُمثِّل «الفلسفة الجديدة» المزعوم. وجد «كاستورياديس» أن استجابة «برنارد هنري ليفي» كانت سيئة السمعة مثل كتابه.
من اللافت للنظر لنا أن انعكاسات «كاستورياديس» يمكن نقلها اليوم إلى قضية «أونفراي». هذا لأن الفيلسوف اليوناني يدرك الروح، أو بالأحرى نقص الروح، في عصر – عصرنا.
الديموقراطيّة تحت المُساءلة :
تتمثَّل إحدى الأفكار الرئيسيّة لنصّ «كاستورياديس» في تذكيرنا بأنه لا يوجد أمام فكر غير قابل للتغيير أيّ غطاء يبرّر خلوده؛ كما لا يمكن أن يكون وجود الفكر في المجتمع إلّا نتيجة السلوك النشط. بعبارةٍ أخرى، فإنّ الفكر هو مسألة مسؤولية بعضنا على البعض؛ لكن، هذا يعني أيضاً أنّه بسبب نقص المسؤوليات، يمكن تخريب الفكر حقّاً.
عندما يرتبط الفكر ارتباطاً وثيقاً بالفضاء العام، عندها يتمُّ إجراء حوارات بشكلٍ مشترك للمُناقشة والنقد، وهذا ما يطلق عليه بالفكر الديموقراطيّ.
ولئن لم تكن الفلسفة هي الطريق إلى الحكمة -سؤالها ظلّ دوماً يتعلَّق بمعنى المعنى- بما يتماشى مع عبقرية اليونان الكلاسيكيّة، فإنّه يجب عليها مع ذلك إظهار الفضائل. وبما أنّ «كاستورياديس» يصرّ بشكلٍ خاصّ على التواضع، إدراكاً منه أن الفكر يشارك في نشر الفضاء العام، فإن المُؤلِّف الجدير بهذا الاسم يمارس الانضباط الذاتي، وذلك حتى لا يسمح لنفسه بالذهاب ليقول أي شيء. خلافاً لذلك، وتحت طائلة ازدراء جمهوره، وفي ظلّ ديموقراطيّة تحترم نفسها، فإنّه عند ذلك يخضع إنتاج المُؤلِّف للنقد، بل ولنقد معيَّن، وذلك مثل المُحرِّرين الذين تتمثَّل وظيفتهم في ضمان الصرامة التي تشكل مهنة المُفكِّر.
وهكذا، فعندما يتمُّ امتصاص الفضاء العام في كثيرٍ من الأحيان من قِبَل أولئك المُدافعين المأذون لهم من طرف الأشخاص الذين لا ينبغي الترويج لهم، وذلك بقصد التخلص من نفاياتهم بكثرة؛ فإن ذلك يعدُّ محواً للديموقراطيّة نفسها.
إستبداد البضاعة :
إنّ آلية المحو لصالح ما يُسمَّى «الدمقرطة»، هي، في الواقع، تسليع «الفكر»، وهذا ما تديره حصرياً الحالات الحسّاسة للسلطة، وذلك للإيقاع واحتلال مساحات خاضعة لأخبار مفبركة قبلياً، بهدف توسيع رأسمالها الرمزيّ والاقتصاديّ.
يحذِّر «كاستورياديس» بأنّ الرقابة هنا لا تنفع؛ وهذه، أوّلاً وقبل كلّ شيء، هي حقيقة التسليع المذكورة التي تمنع عملياً أي مؤلِّف من تأكيد الطابع المُتأنّي للفكر عبر وسائل الإعلام ذات الطابع التقني والتجاريّ. ذلك أنّه، وكما قال «دولوز»، فإن «المفهوم» هنا يصبح من اختصاص المُعْلِنين.
دعونا نترك الأرضية لـ«كاستورياديس»: في عمله «جمهورية الآداب»، حيث كانت هناك -قبل ظهور المُحتالين- أخلاقٌ وقواعد ومعايير. فإذا لم يحترمها أحدٌ، يكون الأمر عندها متروكاً للآخرين لاستدعائه وتحذير الجمهور منه، أمّا إذا لم يتم ذلك، فإنّه من المعروف منذ فترةٍ طويلة أن الديماغوجيّة غير المُنضبطة هي التي تؤدِّي إلى الاستبداد، فتولِّد الدمار وتجعله يتسيَّد المشهد. لذلك، من المُفيد التأكيد على أنّ الأعراف والسلوكيات الفعَّالة والعامّة والاجتماعيّة هي أهمّ ما يفترضه البحث المُشترك عن الحقيقة.
لا يفوّت «أونفراي» أيّة فرصة، في الفضاء العام وعبر المنابر المُختلفة، دون أن يتحدَّث ويدعو عبر أسطوانته المشروخة إلى تشكيل «جبهة شعبيّة – Front Populaire». إنّها الدعاية الأيديولوجيّة التي تعبِّر عن العنوان السياسيّ لفكره.
كاتب المقال :
جان سيباستيان فيليبارت Jean-Sébastien Philippart حائز على شهادة DEA في الفلسفة وشريك (UCLouvain)، باحث مستقل، ومساهم، من بين آخرين، في مجلات ومراكز بحث، منها: عوالم فرانكوفونيّة MondesFrancophones.com وتداعيات فلسفيّة Implications-philosophiques.org