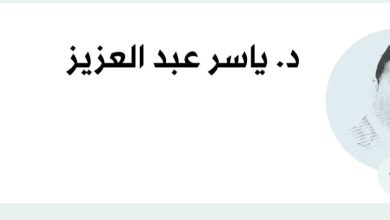مالك بن نبي… كيف يكون إصلاح جهاز التّفكير؟

عبد الرزاق بلعقروز
عن موقع: عروبة 22
يعي “مالك بن نبي” وعيًا منهجيًا حصيفًا، بأنَّ للأفكار وزنها في التَّاريخ وفي رسم مصائر البشرية، لأجل ذلك قام بعملية تشريح لجهاز التفكير، لكن ليس على طريقة المنطق النَّظري الذي عُرِفَ به الفيلسوف الألماني “إيمانويل كانط”، الذي حلَّل ملكات التَّفكير ورسم لنا خريطة الوعي وعلاقته بالعالم الخارجي، فهي محاولة من منظور فلسفة المعرفة، بينما “مالك بن نبي” شرَّح عالم الأفكار من منظور الوعي الاجتماعي والدّور التّاريخي، ومن منظور كيفية تحويل الأفكار إلى قِوى دافعة ورافعة في التَّاريخ، وبالتَّالي، فإنَّ إعادة فتح هذه الورشة الفكرية تعدُّ لازمة حضارية في ظل أزمات العالم العربي والإسلامي اليوم، لأن ثمة فوضى فكرية وثمة قطيعة بين الكلمات والأشياء، وثمة انتصاب لأشخاص باتوا هم أوْلىَ بالتَّفكير من غيرهم، فضلًا عن هذا الميل الشَّديد إلى عالم الأشياء والدَّوران حول معايير الكم في التفكير والتَّقدير وإرادة التقدُّم.
مالك بن نبي… كيف يكون إصلاح جهاز التّفكير؟
إنَّ ما نصرفه من فكر “مالك بن نبي” أمامنا اليوم هو؛ الوعي بإعمال الرُّؤية الكونية في التَّفكير وفي الثقافة، فالرؤية الكونية إما أن تكون رؤية ذات جذور غيبية وأخلاقية، وإما أن تكون ذات جذور مادية تقنية، ونحن بالجذور الغيبية والأخلاقية أَوْلىَ، لأنَّنا مجتمعات الأسُس(1) ولسنا مجتمعات السُّيولة، وأيّة قطيعة بين الرُّؤية الكونية وبين عالم الأفكار، يكون المآل فيها؛ هو الاعتلال والانشقاق بين الوعي والفعل، لنقل إذن بأنَّ عوالم أفكارنا يجب أن تتأسَّس على رؤية كونية كلية وليس على رؤية مادية تقنية، تُشارف اليوم على نهايتها مع الحضارة الغربية التي تحالفت فيها ثقافة التّرف والتوحّش بشكل غير مسبوق.
المال ليس هو العنوان الذي يقتدر به الإنسان على الكينونة إنّما الطَّاقة الإبداعية التي تمتلك الأفكار وتستولدها من ذاتها
وفضلًا عن هذا الوعي، فإنَّنا في امتساس الحاجة كذلك إلى أفكار دافعة أو إحياء الأفكار الدَّافعة، التي يُمَثِّل عليها بن نبي بالفكرة الشيوعية، التي استطاعت أن تتصدَّى للمَد الألماني النازي في ستالينغراد “روسيا”؛ والمثال الذي يَمْثُلُ أمامنا كفكرة دافعة، هو هذه الصَّلابة والقوة التي لاحظناها عند الفلسطينين المقاومين في تصدِّيهم للاحتلال الصّهيوني، في معركة “طوفان الأقصى” الذي يُعبّر عن الفكرة الدَّافعة في مرئيّتها الاجتماعية والتَّاريخية، فلولا الفكرة المُقَاوِمة الدّافعة؛ لما استطاع أن يكون هذا التَّحدي وهذا الصُّمود؛ ليس في وجه الاحتلال فقط، وإنّما في وجه تحالف دولي، توهَّم أنه يُمثِّلُ قانون العدل؛ بينما تُمثِّل المقاومة الفلسطينية قانون الإرهاب.
يمكن أيضًا، صَرف القول إلى أنّ من شروط حيوية مشاريعنا الفكرية والإصلاحية: الموازنة بين عالم الأفكار وعالم الأشياء، فالميل إلى المنزع الكمي، هو أسلوب غربي في التَّفكير والتقدير، وألقى بضلاله على ثقافة العالم الإسلامي في صورة التَّكديس، فالتَّكديس هو الجهة التي تُؤْتى منها التَّبعية والاستعمار، فلا معنى أن تُكَدِّسَ التقنيات المصنوعة في الغرب، لأنَّك تمتلك المال، فالمال ليس هو العنوان الذي يقتدر به الإنسان على الكينونة في العالم، إنّما الطَّاقة الإبداعية التي تمتلك الأفكار وتستولدها من ذاتها، وتَشْرع في البناء الصِّناعي انطلاقًا من الخصوصيات الثقافية، وليس اتّباعًا لخصوصيات ثقافية أخرى. فالمطلب إذن، هو تحسين التَّفكير، كي نستطيع تفعيل الإمكانات والوسائل التي بين أيدينا ومن خلفنا.
ثم إنّ ثمَّة قانونًا آخر، ما أشدَّ الحاجة إليه، هو الوعي بقانون “انتقام الأفكار”، في سياق إرادة التَّغيير والبناء؛ فالعمل الذي لا يشتقُّ قوانينه من الثقافة ومن المعايير العِلمية، ويميل إلى تغليب اللَّاتخطيط والعفوية والفساد، يكون مآله الفشل وبصورة صادمة، مثال ذلك، أنَّنا في سياق البحث عن إصلاح في الجامعات والمدارس التَّعليمية، لا معنى للعقل المُكتظ الذي يُتقن حشو الأذهان، من غير مخطط استراتيجي واضح، أو يفهم الجودة بمعايير كمية مادية، تظهر في تعديد مراكز الأبحاث والجامعات، واقتباس العُلوم الجاهزة من تاريخ العلوم أو راهنًا في الغرب؛ وينتظر الإبداع والتميّز والـتأثير في المجتمع، كلا!، إنَّ إصلاح منظومة التَّعليم يجب أن يراعي السياق والقدرة على الإدماج في السِّياق، فالعلوم التي نتعلَّمها، خاصة العلوم الإنسانية والاجتماعية، من اللَّازم أن تكون علومًا ذاتية داخلية، تنفتح على المعرفة الغربية في أفقها المنهجي وليس في خصوصيّتها الذَّاتية، وتتعالق من حيث الإشكاليات مع التحديات الراهنة.
العصر هو عصر الفعالية والاقتدار الذاتي
إنّ عدم مراعاة قوانين التَّفكير وقوانين الاجتماع والرُّوح الثقافية، سيكون مآله الفشل، وهذا القانون الذي رسمه “مالك بن نبي” هو القانون الذي به استطاعت المجتمعات الحضارية أن تملك وأن تسود؛ وتتحقَّق بالعدل الاجتماعي وكرامة المواطن، أمَّا المجتمعات التي يسود فيها الإخلال بالقانون النَّفسي والاجتماعي، وترتهن إلى القيادات التّاريخية أوالشَّخصيات المتعالية؛ فإنَّ طاقة الحركة تتعطَّل والقدرة الحضارية تخبو، لأن المجتمع الذي لا يكون مجتمع مؤسَّسات وتشريعات علمية، فإنَّ الأفكار ستنتقم منه وترمي به إلى خارج الذات من غير فعل ولا أثر في العالم. كمن يبني جسرًا ويَغُش في مواده الاستعمالية، فمع مرور الزمن، حتى وإن بدا هذا الجسر في الظاهر صالحًا، لكنّه سينهار لأنّه غير مبني على المتطلّبات الحقيقية في نظامه الهندسي.
فلا يكفي إذن، أنّ نرافع عن أنَّ الأفكار المقدّسة هي هويتنا، لا بد من ضمان النجاح لها في الواقع، فالعصر هو عصر الفعالية والاقتدار الذاتي.
( 1) عبارة “مجتمعات الأُسُس”، من وضع أستاذتنا الفيلسوفة الجزائرية: نورة بوحناش.