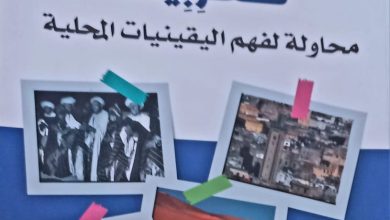المركزية الغربية وثنائية شرق – غرب في رواية «آخر أيام الباشا»
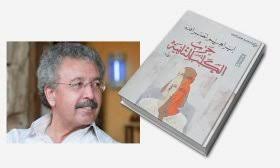
بقلم: ابراهيم الحجري
موقع : القدس العربي.
تسلط رواية «آخر أيام الباشا» الضوء على حدث تقرب محمد علي باشا من الملك الفرنسي شارل العاشر؛ بعد أن ورطه ابنه إبراهيم في دعم العثمانيين إبان حربهم ضد اليونان، حارقا أوراق والده مع الحليف الفرنسي، فخاف محمد علي غضب الملك الفرنسي. ولتحاشي انتقامه استشار القنصل الفرنسي الخائن والعميل رناردينو دروفيتي في أمر الهدية التي ستطيب خاطر شارل العاشر، وتعيد الدفء إلى العلاقات الفرنسية المصرية، فأشار عليه باستقدام زرافة افريقية، من السودان وإرسالها إلى الملك هدية وعربون مودة ومحبة، غير أن الهدية الغريبة ستخلق الحدث، من خلال الإثارة التي خلقتها، وهي تسافر عبر محطات من السودان، فمصر، ثم مارسيليا، عبورا للنيل والبحر المتوسط، قبل أن يستقر بها المقام في العاصمة الفرنسية. ولم ينته الأمر عندئذ، بل أقامت الدنيا وشغلت الناس، هي ومرافقيها؛ حتى بعد مرور أكثر من قرنين من الزمن.
اتخذت الزرافة بعْدها الأسطوري من خلال الإقبال الجماهيري على زيارتها، والنظرة العجيبة التي ألصقها بها المجتمع الفرنسي بوصفها حيوانا شرقيا افريقيا يختزن الكثير من أسرار القارة السمراء، التي لطالما رأى فيها الفرنسيون أرضا للعجائب، والغرائب، والأساطير، والسحر والإثارة، والمواد الخام، وكنوز الطبيعة، وعائدات التجارة وأسواقا لاستيراد العبيد، ولم تقف القصة عند حدود معالجة مسار الزرافة الافريقية (الافريقية الجميلة، الزرافة الدبلوماسية، الزرافة الشرقية، الزرافة السودانية) بل سارعت إلى إضاءة الحياة الإنسانية المجاورة، سواء ما يتعلق بطريقة عيش مرافقيها، ومشاعرهما، وأحاسيسهما، وثقل تركتهما الممتدة في بلدانهما، ومصيريهما بعد نفوق الزرافة، خاصة أنهما لم يكونا معولين على مجاوزة شهور على أكثر تقدير، فإذا بهما يضطران لقضاء سنوات عديدة؛ مرت عليهما مرور القرون، أو من حيث تصوير الحركية الثقافية والفنية والاجتماعية التي كانت تعرفها آنئذ، مدينة الأنوار.
يتوزع المتن الروائي إلى قسمين؛ قسم يعرض القصة الأصلية المخصصة للوقائع التي عرفتها المرحلة الأخيرة من حكم محمد علي باشا، ومن بينها صنعه الحدث بإهدائه ملك فرنسا أغرب هدية في التاريخ، وهي عبارة عن زرافة افريقية، ونقلها إلى فرنسا في سفينة خاصة تحت حراسة مشددة، وبتغطية إعلامية واسعة، وما حيكت حول الموضوع تاريخيا؛ من طرائف وغرائب وعجائب. وقسم ثانٍ يبدو، في الظاهر، ثانويا، غير أنه، في الباطن، يعد الأهم في العمل الروائي، ويتعلق بمشاق البحث عن الحقيقة التاريخية، وصعوبة الإتيان بأطاريح تخالف الروايات الرسمية، قد تصل حد التصفية الجسدية، مثلما حدث للدكتور»مصطفى جهاد» الباحث في التاريخ الذي تقاعد طوعا عقب إحساسه بالتعب، فأراد أن يستريح من مهمته المضنية، ليتفرغ لذاته ويرمم ما ضاع من عمره؛ قبل أن يستفيق حماسه؛ بفضل استشارة من صديق قديم يدعى «أكمل حامد» يسأله فيها عن معطيات تتعلق بالزرافة الافريقية، التي أهداها محمد علي باشا إلى ملك فرنسا للاستفادة منها في تكوين نظرة شاملة حول أنواع الزرافات؛ في وقت بات هذا الحيوان اللطيف مهددا بالانقراض. لتكون هذه الاستشارة فاتحة وحافزا سرديا، بالنسبة للبروفيسور المتقاعد مصطفى جهاد، كي يستعيد أنفاسه في مجال البحث التاريخي، ويقوي حيويته ونهمه لتمحيص الأحداث والوقائع ومقارنتها، وإيجاد القرائن على صحتها أو غلطها.
2. المركزية الغربية وثنائية (شرق-غرب):
تصور الرواية، بوعي عالٍ، حضور المركزية الغربية في التمثيل الثقافي والسياسي العربي، من خلال النموذج الفرنسي؛ إبان حكم محمد علي باشا، والنظرة المزدوجة التي يحملها الغربي حول الشرق، فبقدر ما يسوق المستشرقون ومن يحذو حذوهم؛ صورة َالغرب البراقة التي يشكل العلم والحضارة والتقنية واجهتها المغرية؛ فإننا نصادف الصورة المبطنة التي يختزنها هذا الوجه المزيف والمموه؛ الذي يخفي النفعية، والهيمنة، والرغبة في الاستحواذ على ثروات الشرق والجنوب، وتوظيف مواردهما البشرية للسخرة والاستعباد؛ ناهيك من نظرة الاستخفاف والدونية بالشرقيين والجنوبيين، وتحقير طاقاتهم، وقدراتهم، مع اعتبارهم دون الغربيين رجاحة عقل، وقوة ذكاء.
لقد وظفت الرواية هذه المفارقة الصارخة في التمثل الغربي لثقافة الشرق، منتقدة المركزية الغربية المتطرفة التي تنتهك حرمة الشعوب الشرقية وتتعامل معها بمكيالين؛ على اعتبار أن التحول الناجم عن التهكم، هو تطورٌ وسمو من الأسفل نحو الأعلى، من الصبا إلى الرشد، من اللاوعي والغريزي إلى الوعي والاكتساب. يقول الراوي، على لسان شخصية عطير؛ مبرزا الغطرسة التي تتعامل بها كل من فرنسا ومحمد علي باشا مع افريقيا: (هؤلاء الأوروبيون يعتقدون أن محمد علي وبلاده وخيرها ملك لهم، إنه الأسلوب نفسه الذي يتخذه الباشا تجاه افريقيا؛ فهو يشعر بأن هذه الأراضي بكل ما فيها ملك له؛ ونحن لسنا سوى عبيده. مثل شعار: «القوي يأكل الضعيف»).
بفعل الرمزية التي احتملتها هذه العلاقة الغريبة بين حسن الشرقي وشانتال الغربية؛ صارا معا هدفا مركزيا لهجومات مسعورة من كل النخب والنظام وكل مكونات المجتمع الفرنسي، وبات الهم الوحيد هو التخلص منهما تفاديا للضغط والحرج.
في الوقت الذي تحكي روايات عن بطش محمد علي باشا وشراسته ضد خصومه، وقسوته على شعبه، وخدمة أجندات الغرب، خاصة فرنسا حليفته الرسمية ومدعمة حكمه، تستغرب روايات تاريخية أخرى الظلم الذي تعرض له الرجل، والتهجم المغرض الذي قامت به بعض الأقلام المناوئة، بفعل طمسها للأعمال الفضلى التي أنجزها، والخدمات الجليلة التي قدمها للثقافة والحضارة العربية، على جميع المستويات، وتركيزها على المساوئ والهنات التي لم يخل منها حكم بشري؛ مهما كانت عدالته، ورجاحة قراراته.
جسدت الروايةُ المواجهةَ بين الشرق والغرب على عدة مستويات، خاصة الثقافية والمعرفية والسياسية، فعلى المستوى السياسي؛ تحكم الغرب، بقيادة فرنسا، في كثير من قرارات دول الشرق، وخططها التنموية، وسلط هيمنته عليها، ما جعلها فاقدة لاستقلاليتها، تابعة للآخر الأقوى سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وعلى المستوى العلمي؛ بينما يرفل الغرب في نعيم منجزاته العلمية والمعرفية التي بوأته مراتب عليا، يظل الشرق متمسكا بأساطيره، وخرافاته التي تحجب عنه ضوء المعرفة العلمية، وتجهض أي محاولة للانعتاق ومسايرة الركب، ومنها الإيمان ببركة الأولياء وبالأطاريح الخرافية المضللة، والأوهام التي لا تستند إلى أي أساس منطقي أو علمي. أما على المستوى الثقافي، ففي الوقت الذي تعرف فيه الساحة الفرنسية حراكا فكريا وفلسفيا وإبداعيا وتشكيليا وفنيا، يتجسد في المعارض والمسارح ودور الثقافة والصالونات والمهرجانات والندوات الحافلة، التي تقام على مدار الأسبوع، ويحج إليها جمهور كثيف، فإن الشعوب الشرقية والافريقية تظل عاجزة عن خلق هذا التميز؛ بفعل معاناتها من القهر والفقر والقمع، والجهل، والوصاية، وبعيدة جدا عن فهم أهمية هذه المؤسسات والمكونات الثقافية في الارتقاء بالذائقة، والنهوض بالمجتمع، وتغيير أحواله عامة نحو الأفضل. وقد انصرف الكثير من كتابات المستشرقين وأعمالهم الفنية إلى تجسيد هذا التعارض، وتصوير الشرق والشرقيين وحضارتهم بكثير من التعالي والسخرية والدونية.
رصدت الرواية، بصورة كاريكاتيرية، افتتان الشعب الفرنسي بالشرق وافريقيا، من خلال الهوس الذي انتابه اتجاه هذه الزرافة الافريقية العربية؛ تأثرا بالصورة التي يستبطنها ذهنه عن الشرق والأسطورة والخرافة وكل ما هو عجيب وغريب. فما إن وصل هذا الحيوان المدهش إلى باريس؛ حتى أقبل عليه الفرنسيون من كل ضواحي فرنسا لإلقاء نظرة عليها، وإرواء الشغف الفضولي. إذ عمل المصممون والكتاب والخبازون والنحاتون والحلاقون والنساجون والحرفيون والخزافون إلى استغلال هذا الاحتفاء بشكل الزرافة، لتحقيق الإقبال المنقطع النظير على الربح والبيع، انسجاما مع روح الزرافمانيا التي سادت البلد. غير أن اهتمام النخبة بقدوم الزرافة؛ ليس مثل اهتمام عامة الناس، بحكم أن التصور الأول ينظر إليها باعتبارها ظاهرة عجيبة وغريبة وفلتة من فلتات الطبيــعة تماما كما نظروا إلى جسد الفتاة الجنوب افريقية «سارتجي بارتمان» ذات المؤخرة الكبيرة التي أثارت البريطانيين، فوعدوها بالشهرة والمال ونقولها إلى لندن، ليتم انتهاك حرمتها وتسخير جسدها للإمتاع وتسلية الناس، وتعريضه للتبخيس، استنادا إلى نظرة دونية متعالية ترى إلى الجنس الأوروبي على أنه الأنقى والأرقى، وأن الأجناس الأخرى دونه. وحتى بعد موت سارتجي والزرافة، كان مصيرهما متشابها، حيث تم الاعتداء على جسديهما، والتنكيل بهما تحت ذريعة البحث والدراسة، بعد أن عرضت جثتيهما في المتاحف لاستقطاب الزبائن؛ وتحقيق الإثارة المخلة بحقوق الغير وكرامته الإنسانية.
زادت احتفالية الصراع بين الشرق الغرب، على مستوى الثقافة، بقلب الظاهرة الزرافية المجتمع الفرنسي رأسا على عقب، وإشغاله، وإفتانه. ولم يقف ذلك عند هذا الحد، بل صار كل من صحب الزرافة طرفا في ثقافة تريد فرض ذاتها، وتتعرض للظلم من قبل الذات قبل الآخر، وتصل درجة التنكر لها إلى مستوى مجحف. فقد صار «عطير» ملازم الحيوان الخرافي، صلة وصل بين الزوار والافريقية الجميلة، وراح يغتني من جيوب الفرنسيين مقابل تهيئة الجو لهم لتفحصها وتأملها ولمس جسدها، مثلما صار «حسن الشرقي» المجهول الهوية، مثار إعجاب الوسط الفني والثقافي، بفضل إعجاب الفرنسية «مدام شانتال» به، وارتباطها به، وهيامها به إلى حد إقامة علاقة جسدية بينهما، ورفضها الارتباط بغيره من الفرنسيين النبلاء، الشيء الذي أغضب المجتمع الفرنسي؛ خاصة النخبة التي رأت في تعلق الفرنسية النبيلة برمزيتها الكبيرة في المجتمع- باعتبارها الأرملة الجميلة، معشوقة الكتاب والفنانين، وصاحبة النفوذ الثقافي القوي، والحضور اللافت، ذات الصالون الثقافي الأشهر في باريس وقتها- خسارة للثقافة الغربية، وانتصارا للثقافة الشرقية، وتفوقا من الفحل الشرقي القوي على الفحل الشرقي، وقهره لجسد الأنثى الغربية إلى درجة افتتانها بشبقه وقدراته القاهرة على الفتك بالرغبة وإطفاء نارها الحارقة. يقول السارد «أثار حسن الرأي العام الفرنسي. لم يعد مجرد حارس جاء من بلاد بعيدة دافئة؛ بصحبة حيوان طويل العنق، بل الأمر أصبح أكثر من ذلك بكثير؛ وأخذ منحنى أكثر جدية، وأكثر خطورة مثلت علاقته بشانتال، علاقة الشرق بالغرب، ووجد البعض أن استسلام شانتال له وإقامة علاقة جسدية معه؛ هو تفوق الشرق المتمثل في حسن الشرقي البربري الجاهل على الغرب الأرستقراطي المتعلم المتمدن، على الرغم من صعوبة استيعاب الفكرة؛ فهناك نسبة كبيرة من المجتمع الفرنسي كانت تصدقها وتؤمن بها».
بفعل الرمزية التي احتملتها هذه العلاقة الغريبة بين حسن الشرقي وشانتال الغربية؛ صارا معا هدفا مركزيا لهجومات مسعورة من كل النخب والنظام وكل مكونات المجتمع الفرنسي، وبات الهم الوحيد هو التخلص منهما تفاديا للضغط والحرج. لذلك، فرت شانتال إلى الجنوب تاركة الجمل بما حمل عقب الهجمة الإعلامية الشرسة التي اتهمتها بالفسق والدعارة؛ وخيانة الضمير والأُمة، تاركة حسن الشرقي في حيرته، إذ لم تعد باريس تُطاق بدونها. حتى فوجئ يوما، بالفخ الذي نُصب له، مع أنه لم يكن رجلا مهما إلى هذا الحد، ولم يكن يوما، يطمع في شرف ترويع النخب والمجتمع الفرنسي كله بهذه الطريقة، رغم كونه مجرد جندي في قوات الإنكشارية العثمانية؛ يقول الراوي: «هو الذي عاش عمره كله يعاني من أنه مجرد نكرة. يعيش وفق أهواء الآخرين، ويلبي رغبات الآخرين. حتى الحروب التي خاضها كانت من أجل أرض لم تكن أرضه، ووطن لم يكن ينتمي إليه. حانت اللحظة ليكون شخصا مهما… مهما إلى حد أن يفكر أحد في قتله، ليس سجنن، وليس نفيه، بل قتله. للمرة الأولى في حياته يشعر أنه مهم. ابتسم من أجل ذلك، ابتسم لأننا ستكون المرة الأولى والأخيرة… حملوا الجوال وألقوا به في النهر بعد أن أثقلوه بالحجارة، ليقبع الجسد في القاع ولا يبارحه أبداً».
في رمزية التاريخ التخييلي، ما عادت الزرافة وحسن وطريف عناصر مادية سطحية في واقعة الأهم فيها أثرها، بل صار الأمر متعلقا بملفوظ له دلالاته الأعمق في تاريخ علاقة الشرق بالغرب، والصراع بينهما حول التراث الحضاري، وضمنه السعي المتصل للغرب على فرض التفوق حتى بأشنع الأساليب.
٭ ناقد وروائي مغربي.