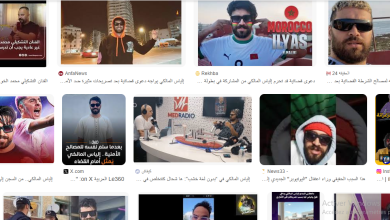موقع: إيطاليا تلغراف
الدكتور حسن أوريد
أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط وببوردو
بلغَ العدوانُ الهمجيّ الذي يتعرَّض له المدنيون في غزّة ذِروتَه مع قصف مستشفى المعمداني، ثم القصف المروع أمس ليلاً. ذهب ضحية قصف المستشفى وحده زهاءَ 500 شهيد، ما بين مدنيين وجرحى وطاقم طبي ونساء وأطفال. تعتبر هذه الهجمات الأخيرة تحولاً خطيراً -في الهجمة التي تشنّها إسرائيل على غزة- سيؤثر على مسار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والصراع العربي الإسرائيلي، وعلاقة العالم الإسلامي بالغرب عمومًا.
بدا جليًّا اصطفاف الغرب مع إسرائيل، منذ شنّ إسرائيل هجماتها على غزّة، وذهبَ الأمرُ إلى حدّ منع مظاهرات التعاطف مع الفلسطينيين، كما في فرنسا، والتَّضييق عليهم في بريطانيا، والأنكى ما عبّر عنه الرئيسُ الأمريكيّ جو بايدن أثناء زيارتِه إسرائيلَ، في تبنّيه الروايةَ الإسرائيلية فيما يخصُّ قصفَ مستشفى المعمداني، ناهيك عن الدعم الكامل والشامل لإسرائيلَ في عملياتها العسكرية، وتحرُّك الأسطول السادس، وتصريح بلنيكن بالتغاضي عن التجاوُزات الإسرائيلية.
تدركُ الولايات المتحدة وإسرائيلُ خطورة قصف مُستشفى به مدنيون وجرحى وأطفال ونساء، مع حصيلته الثقيلة، ولذلك بادرتا إلى إلقاء اللوم على “الطرف الآخر”، وشفعت الولاياتُ المتحدة بتسجيل مفبرك. ونعلم أنَّ الحقيقةَ هي الضحية الأولى في الحروب، كما يقول الاستراتيجي الألماني جان كلوزفيتس.
تعود بنا مجزرةُ مُستشفى المعمداني إلى نقطة الصفر، أو نقطة الافتراق على الأصحّ، أولًا ما بين الفلسطينيين أيًا كانت تنظيماتُهم، وتواجدهم، في القطاع والضفة، وإسرائيل والشتات، وما بين الإسرائيليين. منذ الآن يقوم سورٌ ما بين الإسرائيليين من جهة، والفلسطينيين والعرب والمسلمين من جهة أخرى، ما يجعل إمكانية الحديث والحوار والمفاوضة واللقاء، لغوًا غيرَ ذي فائدة.
تبخّرت كلّ الأماني والأمالي، منذ أسلو وأشكال التمويه الأخرى، من المبادرة العربية، بل حتَّى تلك التي ترعاها الولايات المتحدة، كما اتفاقات أبراهام. ربما كان البعض يُمنّي نفسه بأنَّ الولايات المتحدة والغرب، أمام التحدي الذي تطرحه كل من روسيا والصين، فقد تسعيان إلى بناء علاقات جديدة مع العالم العربي، تنبني على الثّقة والاحترام، دون أن يُجحَف الفلسطينيُّون حقَهم في تقريرِ مصيرِهم.
أضغاث أحلام، كل ذلكَ. تبخَّرت تلك الأماني مع قصف مستشفى المعمداني. هناك بحر من الدماء والدموع والمآسي، يجعل شبه مستحيل على السلطة الفلسطينية -رغم البرغماتية التي تحلّت بها- التعاملَ مع إسرائيل، على أي مستوى، وفي أي نطاق.
أمَّا على المستوى العربي، يسود، جراء العدوان على غزة، غليان وغضب في الدولتين العربيتين اللتين تشتركان وإسرائيل في الحدود، وتربطهما بها اتفاقات دولية، مصر بمقتضى “كامب ديفيد” (1979)، والأردن بمقتضى اتفاقية “وادي عربة” (1994). لا يقتصر الغضب على شعبَيهما، بل انتقل إلى قيادتَيهما اللتين تُحذران من خطر التصعيد إن ركِبت إسرائيل رأسَها وأقدمت على الخُطة غير المعلنة لإجلاء سكان غزة إلى سيناء، وأهالي الضفة إلى الأردن. وهو احتمال لسوف ينسف الهندسة التي بنتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط زهاءَ نصف قرن، وحجرُ زاويتها اتفاقُ كامب ديفيد.
أمَّا الدول التي وقّعت اتفاقات أبراهام، فتجد حكوماتُها نفسَها في حرج شديد أمام شعوبها. في المغرب خرجت مئات الآلاف من المتظاهرين في الرباط للتنديد بالعدوان على غزة، والتضامن مع الفلسطينيين والمطالبة بوقف التطبيع، وفي البحرين خرج متظاهرون بالآلاف، وأبلغت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة فور شنّ العدوان على غزة عن وقف اللقاءات التي كانت تهيئ للتطبيع، وأدانت في بيانٍ شديدِ اللهجة قصفَ المُستشفى المعمداني.
لقد كانَ الأمل قويًا بعد عشرينَ سنة من الشرخ الحضاريّ بين الغرب والعالم الإسلاميّ، جراء أحداث 11 سبتمبر، في تجاوز حقبة خلّفت ندوبًا عميقة ومآسي جمّة. كانت الحربُ على الإرهاب -ساحتُها العالمُ الإسلامي، وأهدافُها المسلمون في البلدان الإسلامية والغربية، بمختلف الوسائل المخابراتية والأمنية والإعلامية والثقافية- حربًا بشعة حَسَب بن رودس، كبير مستشاري الرئيس أوباما، في مقال له في مجلة فورين بوليسي (أغسطس 2021). كانت الولايات المتحدة والعالم الإسلامي ضحيتَين لهذه الحرب، أو الخاسرَيْن الأكبرَين. رأى الكثيرون من الملاحظين أنّ إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان -بعد أسابيع معدودة من الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر- تحولٌ استراتيجيٌّ في السياسة الأميركية، من شأنه أن يطوي صفحة الصدام الحضاري، وتغيير أولويات الولايات المتحدة.
يتبخّر هذا الأمل مع قصف مستشفى المعمداني والقصف الغادر أمس ليلاً، ونعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر، أي إلى الانشطار ما بين الغرب والعالم الإسلامي، وتداعيات ذلك على الساحة الداخلية لكثير من البلدان العربية.
اختارت إسرائيل في خطابها أن تستثيرَ الغرب وتحرك هواجسه بمقارنة “طوفان الأقصى” بأحداث 11 سبتمبر والباتكلان.. لكن المقارنة غير مُوفقة؛ لأن 11 سبتمبر عمليات انتحارية، في حين أن طوفان الأقصى” عملية عسكرية ردًا على اعتداءات متكررة، وانتهاك مقدسات دينية بشكل فجّ ومتواتر.
إنَّ تمادي إسرائيل في الغيّ بشنّ عمليات برية، والسعي لإجلاء الفلسطينيين نحو الأردن ومصر، سيكون ذلك فتيلًا للحرب. وهي حربٌ مدمرة، لن تخرج منها إسرائيل منتصرة ولو بدعم الولايات المتحدة العسكري.
هل يخدم هذا الانزياح الغرب ويُبقي على مصالحه، مع تواطئه المريب، كما ظهر في مواقف كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا؟ حتمًا لا. فلن تكسب الولايات المتحدة مشاعر المسلمين، وقد اختارت -ليس فقط الدعم العسكري والدبلوماسي- مشاطرةَ إسرائيل افتراءَها حول قصف مُستشفى المعمداني .
لقد أمضت الولايات المتحدة عشرين سنة لتعترفَ أن حربها على الإرهاب، بما شابها من غلوّ وتهور واختزال، لم تخدم مصالح الولايات المتحدة في نهاية المطاف، يوم كانت القوة الوحيدة والناظم الوحيد لقواعد التعامل، فكيف تكسب المعركة وقد تعدّدت جبهات المواجهة وانتهت الأحادية القطبية. ولسوف تنعكس “الحرب الحضارية الثانية” سلبًا على فرنسا التي تشهد شرخًا كبيرًا بين مكوّناتها.
التطورات الأخيرة وزخمُها، يُظهر بجلاء ألا يمكن القفز على القضية الفلسطينية. تظلّ جوهر الصراع والمفتاح لحل النزاع. وإذا كان الضمير العالمي الغربي يريد أن يضع حدًا لحرب حضارية ستكون منهكة، فبابُها القضية الفلسطينية وَفق الشرعية الدولية.
طبعًا لا يمكن أن نكتفي بإلقاء اللوم على الآخرين، فالوضع الذي يعيشه العالم العربي من فُرقة وتشرذم هو الذي أغرى الآخرين به، اجتراءً ووصايةً، وفرضَ إملاءات.
ولئن استخلصَ العالم العربي العِبرة مما يجري الآن، وما جرى قبله -بعدم المراهنة على أحد من القوى الدولية أو الإقليمية، ووضْع حدّ للفُرقة التي تمزقه، داخليًا، وبَينيًا- فيمكن أن يكون ذلك اختراقًا استراتيجيًا، ومكسبًا مهمًا.
كلنا اليوم فلسطينيون. وينبغي أن نكونه غدًا كذلك، بمعنى أن نتذكر اللُحمة التي تجمعنا. والسَّدَى الذي يشدّ اللُّحمة هو القضيّة الفلسطينية. نعيش لحظة مصيريّة أمام تحدٍ وجوديّ يُحدق بالعالم العربي. فإمّا هبّة، ولن تكون إلا بوحدة الصف، وإما إبقاء الوضع على ما كان، وهو سبيل الاندحار.